ما يلبث ملفّ الجهاز الخاصّ السرّيّ لحركة النهضة الإسلاميّة التونسيّة أنْ يختفي من دائرة الأحداث، حتّى يعود إليها بأكثر قوّة. كان هذا الملفّ وما زال، اللّعنة التي تلاحق الحركة الإخوانيّة التونسيّة كلّما قدّمت نفسها للرأي العام المحلّيّ والخارجيّ، على أنّها حركة قد تركت الإسلام السياسيّ وراءها ودخلت عصر الحداثة والديمقراطية.
فبعد أنْ كشفت لجنة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، عضوي «الجبهة الشعبية» (تحالف يساريّ قوميّ)، اللذين قُتلا في 2013؛ أي بعد سنتين على الثورة التونسيّة وتحت حكم حركة النهضة عن تورّط الحركة عبر «تنظيمٍ سرّيٍّ خاصّ» في اغتيال المعارضين التونسيّين، وأكّدت أنَّ العديد من الوثائق الخَطِرة التي يرجّح ارتباطها بالملفّ مودعةٌ في «غرفة سوداء» في وزارة الداخليّة. عاد ملفّ الجهاز الخاصّ إلى الواجهة، ولكن هذه المرّة بأكثر حدّة وبأدلّةٍ قويّة على وجوده. وقالت الهيئة إنَّ من أدوار هذا «الجهاز الخاصّ» بناء منظومةٍ أمنيّة موازية واستقطاب القُضاة وتتبّع العسكريّين، إضافةً إلى التعاون مع حركة الإخوان المسلمين المصريّة والحصول على معلوماتٍ عن المؤسّسة العسكريّة الجزائريّة وشركة غازها، ومحاولة اختراق سفارة الولايات المتّحدة بهدف التجسّس.

ليس جديداً الحديث عن وجود جهازٍ أمنيّ – عسكريّ خاصّ تابع للحركة الإسلاميّة التونسيّة، لكن صورة ذلك الجهاز وظروف نشأته ومهامه ومساره، بقيت غائمةً إلى حدٍّ ما. لكن المؤكّد أنَّ الجذور والبدايات لم تكن خلال السنوات الأخيرة.
ربيع العام 1964، غادر سيّد قطب سجنه الناصريّ، محمّلاً بقنبلةٍ فتّاكة، على شكل كتابٍ أسماه «معالم في الطريق». بلغةٍ آسرة وأفكارٍ جديدة وتصوّراتٍ خَطِرة، قرّر قطب بجرّةِ قلمٍ أنَّ «البشريّة تقف على حافّة الهاوية» ولن ينقذها من السقوط إلّا «أمّة الإسلام الحركيّ» جهاداً وقتالاً، وليس مطلوباً إلّا إعادة «بعثٍ لتلك الأمّة التي واراها ركام الأجيال، وركام التصوّرات، وركام الأوضاع، وركام الأنظمة». راسماً فسطاطاً للكفر وفسطاطاً للإيمان، وضع قطب في كتابه الخَطِر، خارطة طريقٍ للإسلاميّين، عمادها: «الحاكمية والجاهلية والعُصبة المؤمنة». وهذه العُصبة طليعة الأمّة المجاهدة بكلّ الوسائل، بما فيها القتال والسلاح، حتى تبلغ التمكين وتنفض عنها الركام: «إنّه لا بدّ من طليعةٍ تعزم هذه العزمة، وتمضي في الطريق، تمضي في خضمّ الجاهليّة الضاربة الأطناب في أرجاء الأرض جميعاً. تمضي وهي تزاول نوعاً من العُزلة من جانب، ونوعاً من الاتّصال من الجانب الآخر بالجاهلية المحيطة».
قبل هذه «اللّحظة القطبيّة» الفارقة في تاريخ الحركة الإسلاميّة العربيّة بأكثر من ثلاثة عقود، عزم مُدرّسٌ، مصريّ المولد والنشأة، اسمه حسن البنّا، مع رفاقٍ له، من الأفنديّة الذين يعتمرون طرابيشَ ولا يلبسون العمائم، في العام 1928 على تأسيس جماعةٍ دينيّة. متأثّراً بسقوط آخر خلفاء بني عثمان في إسطنبول، وضياع الخلافة الإسلاميّة نهائياً (1923)، تحت وطأة حركة التاريخ موضوعيّاً، وتصدّع دولة آل عثمان ذاتيّاً. طرح الرجل على نفسه وعلى جماعته مهمّةً مقدّسة، هي ببساطة: «استرداد مجد الخلافة الضائع» عبر سلسلةٍ من المهام الصغيرة، والتي تشمل كلّ مجالات الشأن العام، دينيّاً، وسياسيّاً، واقتصاديّاً، واجتماعيّاً وتربويّاً. لم تكن الجماعة الجديدة التي حملت اسم «الإخوان المسلمين» تضع لنفسها حدّاً موضوعيّاً في نشاطها الذي يراد له أنْ يوجد في كلّ مكان وداخل كلّ قطاع.

شكّلت الجماعة مكتباً يضم الفروع العربية والعالمية للإخوان منذ حياة مؤسّسها البنّا، كما وضعت خطّةً مُحكمةً لنشر مزيدٍ من أفكارها خارجاً، وإيجاد موطئ قدمٍ لها في كلّ ساحةٍ، بذرائع شتّى، منها الدعويّ ومنها الاجتماعي، وحاولت التسرّب إلى شمال إفريقيا تحت غطاء «المساعدة في دفع عمل الحركات الوطنيّة في مواجهة الاستعمار الفرنسيّ»، في تونس والجزائر والمغرب، من خلال محاولة استمالة قيادات حركات التحرّر.
في أربعينيّات القرن العشرين كلّفت الجماعة، توفيق الشاوي، الذي كان طالباً يومذاك في باريس، بالتنسيق مع الحركات الوطنيّة في المغرب العربيّ. سيرتبط الشاوي لاحقاً بتونس في علاقةٍ جدليّةٍ ومعقدّة. في باريس وفي مقاهي الحيّ اللاتينيّ، إذ كان يتجمّع طلبة المغرب العربيّ وممثّلو الأحزاب الوطنيّة المغاربيّة، كان الشاوي يطرح بذكاءٍ كبير أفكاره الإخوانيّة محاولاً استمالة بعضٍ منهم، ولئن نجح مع المغاربة والجزائريّين، لكنّه فشل مع التونسيّين، بسبب وجود جلولي فارس، والذي كان ممثّلاً للحزب الدستوريّ الجديد في فرنسا. كان فارس يقف حجر عثرة أمام الشاوي، لكنّ هذا الأمر لم يمنع الشاوي من إيجاد العديد من الثغرات التي سيتسرّب منها لاحقاً، مستفيداً من التغيّرات الجذريّة التي ستشهدها المنطقة العربيّة بعد موجة الاستقلال والصِّراع الذي طبع العلاقة بين الرئيسين، جمال عبد الناصر والحبيب بورقيبة، أو باللّعب على التناقضات الداخليّة التي شقّت الحركة الوطنيّة منتصف الخمسينيّات.
مياه غزيرة جرت تحت الجسور. وما فشل فيه الشاوي، من نقل دعوة الإخوان من خارج تونس إلى داخلها، نجح فيه حفنة من الشباب التونسيّ الغاضب على بورقيبة. برزت الحركة الإسلاميّة الإخوانيّة في تونس من الداخل. تشكّلت من روافد عقائديّة ومذهبيّة مختلفة: سلفيّة، وصوفيّة، وإخوانيّة، وجهاديّة. فقط كان يجمعها اعتقادٌ راسخ بفكرة أنَّ «الإسلام دينُ ودولة». لكن القاطرةَ كانت إخوانيّةً والتيّار السائد إخوانيّاً، ولذلك أخذ تنظيم الجماعة الإسلاميّة مع منتصف السبعينيّات شكلاً إخوانيّاً، وذلك يعكس مزاج وتوجّه أمير الجماعة، راشد الغنوشي، الذي طبع الحركة منذ نشأتها بطابعه الذاتيّ، فتغيّرت بتغيّر أفكاره وتوجّهاته، تكتيكيّاً وإستراتيجيّاً. وهذه قصّةٌ أُخرى.
فالجلباب الإخوانيّ، الذي عاشت داخله الحركة الإسلاميّة التونسيّة ردحاً من الزمن – ولا ندري هل خرجت منه فعلاً، أَمْ أنّها توهم الناسَ بذلك – كان له الأثر الفكريّ والتنظيميّ على برنامجها السياسيّ وبخاصّةٍ على نهجها في التغيير القائم على «الانقلابيّة» بمعنى الهدم وإعادة البناء. هدم الدولة العلمانيّة الوضعيّة وإعادة بناء دولةٍ إسلاميّة نظاماً وقانوناً، وكانت فكرة الانقلاب تتراوح في مجال التطبيق بين التدرّج، من محاولات أسلمة المجتمع من القاع إلى القمّة تدرّجاً، وبين الحسم بالضربة القاضية. وفي هذا السياق يقول راشد الغنوشي، في مقالة نشرها في شهر مارس/آذار 1981: «إنَّ الإسلام منهاجٌ شامل للتحرّر أو هو ثورةٌ تحرّريّة شاملة. إنّه تحرير البشريّة من الطاغوت، طاغوت الشهوة والخرافات والاستبداد والاستغلال (...) وإذا كان الإسلام ربّانيّاً فمنهاج الدعوة يتلخّص في مرحلتين: مرحلة بناء المجتمع المسلم أو إعادة بنائه أو إصلاحه. ومنهاج الدعوة في هذه المرحلة يتلخّص في البلاغ المُبين والصبر الجميل. مرحلة قيام المجتمع المسلم: فإذا أثمر عمل التوعية الإسلاميّة؛ استجابت الجماهير في قطاعها العريض لهذه الدعوة، فرَضِيت بتحكيم الإسلام في حياتها، وقامت للإسلام دولته وكان على تلك الدولة أنْ تنفّذ حكم الله وتمارس مهامها في نشر العدل ومنع الظلم بين رعيّتها». لكن كيف ستقيم هذه الجماهير دولة الإسلام؟ بل إنَّ هذه الجماهير في قطاعها العريض، كما يصفها الغنوشي، تشمل حتّى ضبّاط الجيش وجنوده وضبّاط الشرطة وعناصرها، فالحركة الإسلاميّة، لا تضع حدوداً لعملها، منطلقةً من فكرة الشموليّة الإسلاميّة؛ فهي لا تقف أمام أبواب الثكنات ولا مراكز الشرطة ودوائر المخابرات، تستميل بعضاً من الذين داخلها وتستقوي بهم وتطلب منهم النصرة.
***
لا تتجاذب الأضداد إلّا نادراً، غير أنَّ علاقة الإسلاميّين، بمؤسّسات العنف في الدولة، أمناً وجيشاً، تطبعها مقولة تجاذب الأضداد. هناك سعي محمومٌ من الطّرفين لمعرفة قدرٍ أكبر من المعلومات والتفاصيل عن الطرف الآخر. وسعي أكثر ضراوة في إخضاع الآخر بين الطّرفين، لكن الحركات الإسلاميّة لم تكن السبّاقة عربيّاً في محاولات الاندساس داخل الجيش والوصول من خلاله إلى السلطة. كان القوميّون واليساريّون سبّاقين في نسج وإنشاء التنظيمات السرّيّة داخل الجيوش من المحيط إلى الخليج. وكان البعثيّون الأكثر براعةً في ذلك. لكن هذا لا يعني أبداً زهد الحركة الإسلاميّة العربيّة في السلطة وفي الوصول إليها من خلال الجيوش وعبرها. وقائع كثيرة حدثت هنا وهناك تدلّ على ذلك.
ومنذ حياة البنّا المؤسّس، عملت الجماعة الإخوانيّة، على تقوية شوكتها بجهازٍ سرّيٍّ شبه عسكريّ يشكّل «طليعةً مقاتلة»، به «تحمي الدعوة من خصومها» يسمّى «النظام الخاصّ» لكن الشيخ يوسف القرضاوي، الإخوانيّ القديم والحاليّ، يقدّم -في مذكّراته الشخصيّة- مهاماً أُخرى لهذا الجهاز الغامض: «ولقد جعلت دعوة الإخوان من شعاراتها منذ ارتفعت رايتها: الجهاد سبيلنا، والموت في سبيل الله أسمى أمانينا. فلا بدَّ أنْ يكون لهذا الشعار مدلولٌ عمليّ في تكوين أبنائها. وكان النظام الخاصّ هو الذي يوفّر ذلك بقوّةٍ وجلاء، ويدرّب الشباب على الأعمال الجهاديّة والعسكريّة اللازمة لكلّ من يُهيّء نفسه للدخول في معركةٍ مع أعداء الأمّة. ويسعى إلى تغيير الحكم العلمانيّ الذي لا يحكم بما أنزل الله، ولا يحتكم إلى شريعة الإسلام وقيمه في تشريعه وتقنينه، ولا في اقتصاده وسياسته، ولا في تربيته وتعليمه، ولا في ثقافته وإعلامه، ولا في تقاليده وآدابه، عن طريق (انقلابٍ عسكريّ) تكون طلائعه من أبناء النظام الخاصّ».
تقول الرواية الأمنيّة إنَّ النواة الأُولى التي تشكّل منها الجهاز الخاصّ للحركة الإسلاميّة كانت أساساً من العناصر العسكريّة، «هي نواة ضبّاط الصفّ، عناصرها انخرطت في العادة بعد مرورها بحلقاتٍ مسجديّة أدارها راشد الغنوشي أو كانت في بعض الأحيان من بين تلاميذه، فالرجل تولّى التدريس في القيروان وحمام الأنف بعد عودته مباشرةً إلى تونس. من خلال حلقات النقاش كان يقع التنبه إلى العناصر الأكثر انتظاماً في الحضور أو الأكثر شغفاً في التلقي. وانطلاقاً من سنة 1975 سيبدأ توجيه عددٍ من التلاميذ الذين أخفقوا في الحصول على البكالوريا بعدما أدركوا السنة السابعة إلى مدارس ضبّاط الصفّ. ونجد من بين أعضاء الجهاز العسكريّ الأوائل: جمعة العوني من سلاح الجو، إبراهيم العمري من سلاح الجو، سيد الفرجاني نقيب في الجيش، عبد السلام الخماري من جيش البرّ كانت مهام هذه النواة محاولة استقطاب عسكريّين ممّن يستشفّ أنَّ لديهم استعداداً للالتحاق بالحركة، وكان الجهاز العسكريّ معروفاً في وثائق التنظيم الأمنيّ من خلال رقم 15، ويطلب من طلبة الأكاديميّة العسكريّة الموالين للحركة أنْ يقطعوا صلتهم بها ظاهريّاً وبأصدقائهم المنضوين فيها، وأنَّ يخفّفوا ما استطاعوا من المظاهر العلنيّة في العبادة، وسيكون الصادق شورو، القياديّ بتنظيم الحركة، الذي انتسب ابتداءً من سنة 1975 إلى الأكاديميّة العسكريّة بفندق الجديد كأستاذ كيمياء، رقيباً على الجماعة.
تتقاطع هذه الرواية تماماً مع رواية القيادي في تنظيم القاعدة، أبو مصعب السوريّ، التي بلغته مشافهةً من الضبّاط أعضاء المجموعة الأمنيّة، والتي يقول فيها: «قام مخطّط الجهاز العسكريّ أساساً على زرع عددٍ من الضبّاط المتطوّعين في الجيش التونسيّ في أقسام الأسلحة الثلاثة البريّة والجويّة والبحريّة، وعلى تجنيد من استطاعوا من الضبّاط ذوي الميول الإسلاميّة في الجيش. وبصرف النظر عن التفاصيل الفرعيّة فقد كان التنظيم محكماً وشديد التخفّي في جيشٍ علمانيٍّ يحظر على عناصره الالتزام بالدين، ويراقب حتّى همسات المصلّين وتسبيحات المؤمنين، ويعتبرها شبهة تؤدّي على الأقل إلى طرد صاحبها من الجيش. التزم الضبّاط الشباب من أعضاء هذا الجهاز بالغ السرّيّة بناءً على فتاوى تحصل عليها من فقهاء التنظيم ومن استفتاهم بسلوكٍ يخفي أيّة إشارةٍ إلى التزامهم الدينيّ. فكانوا يصلّون سرّاً؛ بل إذا حضرتهم الصلاة في أوقات الدروس والتدريبات، صلّوا إيماءً. وكانوا لا يصومون إلّا إذا تمكّنوا سرّاً؛ بل وصل الأمر في التخفّي إلى اكتفائهم بلباس الحشمة لنسائهم مع الترخّص في كشف غطاء الرأس للضرورة التي كانوا فيها».
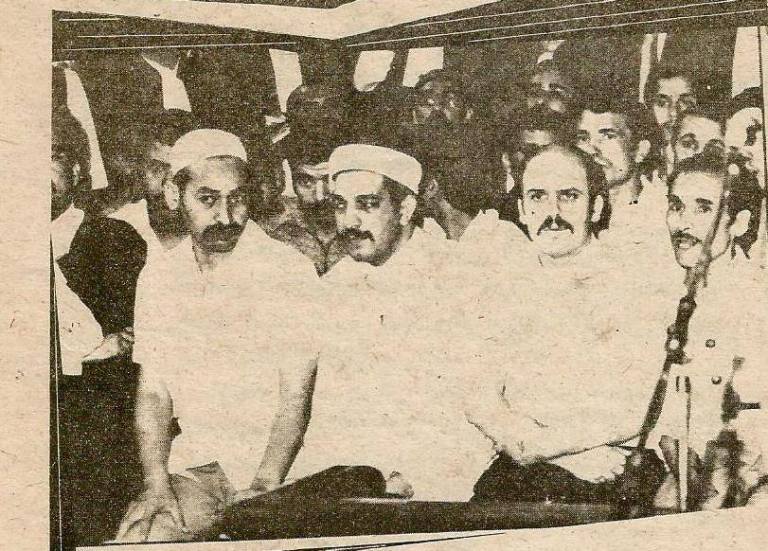
كانت الحركة الإسلاميّة مهتمّةً بالوجود داخل الجيش، فمنذ النصف الثاني من السبعينيّات، أصبح للمؤسّسة العسكريّة حضورٌ قويٌّ في الشأن العام والسياسيّ، بعد أكثر من عشر سنواتٍ من التهميش والضعف في أعقاب المحاولة الانقلابيّة بداية الستينيّات، فقد نزل الجيش في يناير/ كانون الثاني 1978 لمواجهة الغضب النقابيّ وسحق التمرّد بالدمّ والرصاص، وأنقذ النظام. وفي يناير/ كانون الثاني 1980 تدخّل الجيش لواجهة العصيان المسلّح، وبدأ دوره في الصعود تدريجيّاً، بتعيين قياداتٍ منه في خططٍ سياسيّةٍ، وكذلك على رأس مؤسّساتٍ وأجهزةٍ أمنيّة.
كانت الحركة تركّز عملها على صغار الضبّاط، وبخاصّةٍ ضبّاط الصفّ والجنود، لاعتباراتٍ طبقيّة، إذ ينتمي هؤلاء إلى الطبقة المتوسّطة والفقيرة، والتي أصولها من أحياء شعبيّة وقرى وأرياف تحضر فيها الحركة الإسلاميّة اجتماعيّاً وثقافيّاً بقوّةٍ كبيرة. وكذلك لصعوبة الوصول إلى كبار الضبّاط وخطورة ذلك، والأهمّ من ذلك أنّها استغلّت ضعف الدولة منتصف الثمانينيّات، والصراعات التي كانت تشقّ مؤسّسات النظام والحزب وحتى الجيش، بعد أنْ تحوّل إلى مخلّصٍ تستنجد به السلطة لقمع الاحتجاجات الاجتماعيّة والسياسيّة، لتكرّر ذلك في جانفي 1984 خلال ثورة الخبز، عندما حصدت بنادق الأمن والجيش أرواح العشرات. إلى جانب الذراع العسكريّ، يتكوّن الجهاز الخاصّ للحركة، من جهازٍ استخباراتيّ، والواضح أنَّ عمله قد بدأ نهاية السبعينيّات وبداية الثمانينيّات، مع انطلاق الحرب مع الدولة، وبخاصّةٍ بعد انكشافه في عام 1981 وحملة الاعتقالات التي أعقبته وطالت مستوياتٍ عميقة من التنظيم. الرواية الأمنيّة تشير إلى أنَّ الجهاز الاستعلاميّ يحمل في نظام الشفرة الرقم 14. وكانت توجد طليعةٌ قياديّةٌ مدنيّة من الخواصّ تشرف على هذين الجهازين، دون أنْ تربط بينهما مباشرةً، إذْ كانت الصورة على النحو الآتي: قيادةً مدنيّةً، فيها راشد الغنوشي، صالح كركر، حمادي الجبالي، الصادق شورو، علي الزروي، وكان محمّد شمام هو المنسّق العام أو المشرف على الربط بين القيادة وبقيّة الأذرع، فالذراع العسكريّ تقوده نواةٌ صلبة تربط بين القيادة المدنيّة والعناصر العسكريّة لا يتمّ تحديدها بالتراتبيّة العسكريّة؛ بل بالأسبقيّة في الحركة، وبدرجة الولاء الفكريّ والتنظيميّ، والذراع الاستعلاميّ يرتبط بالصيغة نفسها مع القيادة المدنيّة، التي تستقبل منه المعلومات وتحلّلها وتتحرّك على ضوئها.
كانت أجهزة الدولة تعيش حالةً من الوهن الفظيع خلال عقد الثمانينيّات، فقد انعكس الصِّراع السياسيّ داخل معسكر النظام حول خلافة بورقيبة والأزمة الاقتصاديّة الخانقة والصِّراع مع المنظّمة النقابيّة ومع ليبيا، بشكلٍ كبير على البلاد طولاً وعرضاً. في مقابل ذلك كانت حركة الاتّجاه الإسلاميّ تزداد قوّةً يوماً بعد يوم، شعبيّاً وتنظيميّاً، مستفيدةً من أزمة النظام وإخفاقاته، ومن ضعف المعارضة غير الإسلاميّة، لكنَّ موازين القوى بقيت في صالح النظام من الناحية الأمنيّة على وجه الخصوص، وكان الجهاز الخاصّ عاصمها الوحيد من ضربات السلطة.
لم تكن نشأة الجهاز الخاصّ، داخل الحركة الإسلاميّة التونسيّة، بدعةً في تاريخ الحركات الإسلاميّة ولا خصيصة للحركة التونسيّة من الناحية التنظيميّة. كان ميراثاً إخوانيّاً وصدى واضحاً لأصولها الإخوانيّة واتّباعاً منها لسنة الآباء المؤسّسين. لكنَّ التفكير في تحريك الجهاز، بعد 1984 نحو التمكين، أي قلب نظام الحكم، كان واضحاً أنّه من تأثيرات تجارب مختلفة حدثت هنا وهناك. فقد فتحت الثورة الإسلاميّة، التي أسقطت نظام الشاه القويّ في عام 1979، باب الأمل واسعاً أمام الإسلاميّين في كلّ مكان، وكسرت حاجز العجز والخوف. كما ألهمت فكرة الاندساس داخل الجيش، التي قام بها تنظيم الجهاد المصريّ، ووصل من خلالها إلى رأس الرئيس أنور السادات أمام الشاشات في أكتوبر 1981، الكثير من الجماعات الإسلاميّة في العالم ومن بينها تونس، كي تحرّك طاقتها في تقوية أجهزتها الخاصّة، فإمكانيّة التطبيق واردةٌ، والمثال المصريّ خير دليل، والأهمّ من التجربة الإيرانيّة والمصريّة، كانت التجربة السودانيّة، التي أطاحت بجعفر النميري، والتي شكّلت مرحلةً أولى لتمكين الحركة الإسلاميّة من الحكم لاحقاً في 1989، وهي التجربة التي كانت حركة الاتّجاه الإسلاميّ تريد السير على خطاها.
في العام 1987 قرّرت الحركة تحريك جهازها الخاصّ –الذي كان يسمّى المجموعة الأمنيّة– لتنفيذ انقلابٍ عسكريٍّ يُطيح بنظام الرئيس الحبيب بورقيبة في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني، لكن زين العابدين بن علي كان أسرع إلى السّلطة وحسم الأمر قبل ذلك بيومٍ واحد، ثم عقد صفقةً مع قيادة الحركة الإسلاميّة تمّ بموجبها إخلاء سبيل قياداتها من السجون مقابل الكفّ عن اختراق الجيش والأمن، لكن الصفقة ما لبثت أنْ فَشِلت في العام 1989 عندما اكتشف ابن عليّ أنَّ الإسلاميّين ما زالوا يعملون سرّاً للتواجد في قلب أجهزة الدولة الأمنيّة والعسكريّة وأنَّ جهازهم الخاصّ ما زال نشيطاً. حتى بلغ الصِّراع أوجه في العام 1991 وتحوّلت الشوارع إلى ساحات حربٍ بين الدولة والإسلاميّين. لكن الدولة كانت الأقوى وتفرّق أعضاء الحركة الإسلاميّة الإخوانيّة أيدي سبأ، بين السجون والمنافي، حتى عادوا إلى البلاد في العام 2011، في أعقاب سقوط نظام ابن علي واستأنفوا نشاطهم العلنيّ والسرّيّ والسلميّ والأمنيّ والعسكريّ كأنَّ الزمان قد استدار كهيئته في ثمانينيّات القرن الماضي.


