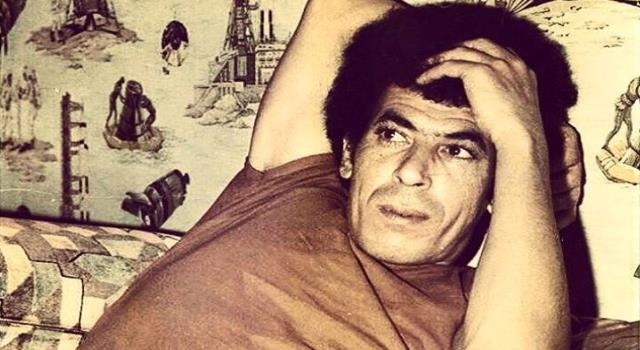يبدو الصادق النيهوم السابق لعصره ، أبرز المفكرين الذين شخصوا المجتمع الليبي ، ونظروا إليه بعمق القاريء المتفحص لأحواله ، كان ذلك منذ ستينيات القرن الماضي ، وكأنه يقرأ يتابع ما يدور اليوم في البلاد المنكهة بالحروب والآلام والفساد والتجاذبات النعنة والخفية
يقول النيهوم « الطريق المتشعب أمام بلادنا يدعونا جميعاً إلى المشاركة في عملية البحث المضنية عن الاتجاه المطلوب الذي يجب أن نجده الآن ونضع فوقه علاماتنا قبل أن تبدأ سنوات التيه. وعلينا أن نفعل ذلك قبل أي شيء آخر سواه، فكل خطوة في الاتجاه الخطأ ندفع ثمنها مرتين» مشيرا الى «إن ليبيا تحتاج الى مدارس ولكنها تحتاج أكثر الى حوار طويل ومتزن يتناول معظم بديهياتنا بالنقاش ، يتناول سلطة الرجل وسلطة الفقيه وسلطة كبار السن » وكاشفا بكل بساطة أنه «ما دام مجتمعنَـا يسْمح لفقيه أمّي أنْ يحشرَ نفسَه بين "العلماء" ويقول ما يشاء لمنْ يشاء باسْم الله شخصيّـاً، وما دام الطّفل لا يستطيع أنْ يفعل شيئاً تجاه ما يسمعه من أساطير الفقيه سوى أن يطوع نفسه للتعايش معها في الظلام، فلا مفر من وقوع كارثة »
سيكون على النيهوم أن يقضي الجانب الكبير من حياته غريبا في ملاذات عدة ، وبين مدن كثيرة ، هاربا من الشمس اللافحة الى الثلج الحارق ، متراوحا بين أفكار وأهتمامات ورؤى وخرافات وأسئلة ومواقف ولغات وحضارات وعقائد طالما ألهمته القدرة على مواجهة قدره ، بعد أن إستشرف مستقبل بلده ليبيا بعيني زرقاء اليمامة ونبوءات عراف يجيد قراءة الرمل « إن ليبيا بلد مبني من القش ويطفو فوق بحيرات من البترول فما أسهل أن تندلع النار فيه ، أن تحرقه من أساسه ، ولكن ذلك لن يحدث الأن لأننا لم نكتشف النار بعد ، نحن المساكين الموغلون في النار والعناد»
بعد رحيل النيهوم إكتشف الليبيون النار التي يحرقون بها بلادهم منذ سنوات ، فالتطرف والإرهاب والصراع على السلطة وثقافة الغنيمة وعقلية الإقصاء والرغبة في إحتكار الثروة المتدفقة من تحت رمال الصحراء القاحلة والتدخلات الخارجية ، كل تلك العناوين تزيد من إضرام لهب المعركة في البلاد ، بينما «الرجال مازالوا يفهمون الوطنية باعتبارها صراخا غاضبا من إهمال الدولة وحدها،وتجميع الأكاذيب المخجلة فوق أرصفة المقاهي في أيام العطلة،والجري خلال أشهرالصيف وراء مؤجري الشقق وباعة البنات على طول ساحل الفقراء مستعرضين حصيلتهم من مدخرات ليبيا،كأن تلك النقود قد جاءت بطريق العرق الشريف » وفق تعبيره
حتى الديمقراطية التمثيلية من خلال الأحزاب التي ظهرت في البلاد بعد 2011 ، إنتقدها النيهوم باكرا ، هو في هذه المسألة لا يختلف عن صديقه اللدود معمر القذافي الذي كان يجتمع معه في جملة أفكار ، وصلت الى حد الإعتقاد بتأثير حقيقي لكل منهما في مواقف وتجربة الثاني ، فالرجلان كانا يتقاربان في العمر والبيئة والفكر والرؤية والإستشراف
يقول النهيوم «إن الديمقراطية الحزبية ليست فكرة طرأت على عقل مفكر، بل بيئة فرضتها ظروف الثورة الصناعية، لم يكن للأوروبيين يد في اختيارها،إلا بقدر ما كانت لهم يد في اختيار جلودهم أو لون عيونهم. ورغم أن شعوبا كثيرة أخرى،قد عمدت إلى تقليدهم،فإن ذلك كان مجرد نوع من خداع البصر بوسائل المكياج المؤقت» ولكن ما الحل ؟ هو يرى إن « الشعوب لا يقتلها الاستعمار ولا تحييها الحرية، ولكنّ فرص البناء المتاحة هي التي تقرر ذلك وحدها.. وليس ثمة شك أن الزمن أهمّ العوامل بالنسبة للبناء والهدم على السّواء » ف«بناء المجتمع الحر يبدأ بكسر عزلة الفرد وكسب ثقته للخروج من مخبئة النفسي» أما «الثورة فلا يحددها الشكل السياسي بل القيم الخلُقية الكامنة وراء جميع أنواع النشاط الإنساني. إنّها تحدث لكي تحقق قيما خلُقية وليس أهدافاً سياسية مجردة من هذه القيم، لكن تاريخ الثورات يشير بوضوح إلى أن الثورات احتواها دائما هدف سياسي ما وسخرها لخدمته حتى أُفرغت الثورة نفسها من محتواها الخلُقي في خدمة أغراضها السياسية »
أن نبوءات النيهوم قبل عقود هي التي جعلته يشير الى «إن ليبيا تحتاج الى مدارس ولكنها تحتاج أكثر الى حوار طويل ومتزن يتناول معظم بديهياتنا بالنقاش ، يتناول سلطة الرجل وسلطة الفقيه وسلطة كبار السن » هذا الكلام موجه بالأساس فهم طبيعة مجتمع ذكوري ، محكوم بثقافة دينية مزورة ، وبسلطة قبلية لم تخرج من قمقم التاريخ الملوث
كان النيهوم نبتا بريا من أرض ليبيا المهيأة عبر التاريخ لإنتاج المواهب بكل أشكالها الإيجابية والسلبية ، وكان منذ بداياته متمردا على الساطة بكل عناوينها، لكن إرتباطه بالبلاد كان واضحا حيث يخاطب أبناء وطنه قائلا : « الوطن ليس قطعة الأرض وحدها، وإذا كانت ظروفي المعقّدة قد قررت مصير ارتباطي بالأرض، فأنا لا أعتقد أن ذلك يعني اقتلاعي من تراب ليبيا، فأنا جزء منكم ولا أستطيع أن أنسى ذلك حتماً إذا أردت أن أنساه» لكنه يشير بشيء من القسوة الى الواقع بالقول «إن مستوانا الخلقي مثل بقية مستوياتنا ما يزال متأخرا رغم كل النوايا الطيبة.والمرء يستطيع أن يلتقط مليون نموذج من ليبيا لتأكيد هذه الحقيقة حتى يصاب بالقيء،فقد ساعدت ظروف الرخاء على إبراز ملامح النماذج إبرازا هائلا لا تتخطاه العين،والرخاء اختبار قاس فشل شعب ليبيا في اجتيازه حتى الآن »
ولكن هلل للفكرة أن تغير الواقع في بلاد العرب ، هنا يقول النيهوم «الزعم بأن تغيير المجتمع رهن بتغيير أفكاره، نظرية فقهية ثبت بطلانها منذ عصر ماركس على الأقل لم يكن بوسعها أن تقدم للعرب حلًا آخر، سوى أن تربطهم إلى عالم ما قبل الثورة الصناعية، وتورطهم في دعوات عقائدية متطرفة، على يد جيل بعد جيل من الأنبياء الجدد. ولعل التاريخ ما زال يخبئ للعرب أكثر من مفاجأة غير سارة، لكن محنتهم خلال حرب الخليج ، سوف تظل شاهدًا كافيا على أن مائتي سنة من خطب الوعظ والإرشاد، لم تنجح في وقايتهم من شر شيطان واحد. إن تجاهل التاريخ، خطيئة عقابها أن يتجاهلك الواقع ، فالعرب الذين يتوجه إليهم الدعاة بالخطاب، ليسوا في وضع يسمح لهم بالإنصات أصلًا. إنهم - مثل ركاب طائرة مخطوفة - أمة لا تملك حق الاختيار، ولا تستطيع أن تقرر مصيرها، وليس بوسعها أن تستفيد من أية دعوة أخرى، سوى تحريضها على استعمال الحيلة، للخلاص من خاطفيها بأي ثمن، وفي أقرب فرصة ممكنة »
يبدو النهيوم قاسيا في نعته للوضع الأخلاقي في ليبيا وكأنه عاش كل تجليات أحدث 2011 وما بعدها من نهب وسلب وحقد وكراهية وقتل على الهوية وإقصاء وإلغاء وتلاعب بالمصالح العليا للبلاد وفساد على جميع الأصعدة وتجاوزات في حق الوطن والمواطن ،وهاهو يقول « نملك مجتمعا يحمل كل سمات المجتمع الجاهل.، فالفرد الليبي يتناقض مع مجتمعه - إذا كنا معترفين بوجود التناقض - لأنه ينطلق من فكرة مؤداها أنه بالذات (مركز العالم)، وأن الدنيا تدور حوله.. لكن مجتمعه يتناقض معه أيضا لأنه بدوره يعتبر نفسه مركز الأرض.. إن أعراض الجهل واحدة بالنسبة للفرد وبالنسبة لمجتمعه.. كلاهما عالم بذاته.. كلاهما على صواب دائما.. كلاهما أناني وجاهز الخطط وعارف بكل شئ.. كلاهما يعتقد أنه يسير في طريق الخير والسعادة» و« اللعبة تمضي دائما على ما يرام ما دامت مصلحة هذين النقيضين تجمعهما معا في نقطة واحدة، لكنه إذا اختلفت مصلحتهما بطريقة ما فإنهما لا يجلسان معا لنقاش طبيعة الاختلاف وتقرير شكل الخطأ والصواب، بل يدخلان فورا في الصدام، فيحقق الفرد مصلحته في الخفاء عن (أعين المجتمع) أو تكتشفه (أعين المجتمع) وتشنقه على باب المدينة. وأسوأ ما في الأمر أن (تحقيق المصالح في الخفاء) لا بد أن يدعو بالطبع إلى نوع من النفاق الاجتماعي الذي ينتهي عادة بأن يرتكب كل فرد في المجتمع نفس الرذائل في الخفاء ويطالب بشنق من يرتكبها علنا. وإذ ذاك تصبح أمراض مجتمعنا أصدقاء سريين»
حتى« الكرم في مفهوم هذا المواطن ( الليبي ) المذعور ليس فكرة من أي نوع، بل (ضريبة) مؤلمة لا بد من أدائها تجاه كل معارفه مهما كلفه الثمن. إذا وجدته في المقهى لا بد أن يدفع عنك الحساب، ليس لأنه يريد أن يدفع بل لأن العادة أن يدفع المرء حساب معارفه إذا وجدوه في المقهى. وإذا تجاهل أداء هذه (الضريبة) فإن معارفه بالطبع سوف يسلخون جلده بألسنتهم الكريمة ويعتبرونه هارباً أبدياً من الضرائب » ثم «إن هذه العقوبة كفيلة بأن تجعل كل أحد يدفع قهوة كل أحد بعد أن يذبح له حصاناً. إنها كفيلة بأن تعطيك مجتمعاً كريماً مثل حاتم الطائي، لكن مشكلتك أنك لن تجد أحداً بين مواطنيك الكرماء يقرر ذات مرة تحت وطأة هذا الكرم أن يعمل شيئاً لله ويكف عن سرقة عداد الكهرباء، لأن سرقة العداد بالنسبة لحاتم الطائي ليست جريمة مدنية، بل غزوة مظفرة ضد قبيلة (بني مؤسسة الكهرباء). إنه قاطع الطريق الذي خدع كتب الأدب وجعلها تعتقد أن المرء يقطع الطريق فقط لكي يذبح حصانه لعابري الطريق» وفق رؤية النيهوم الذي يواصل الإمساك بمشرطه ليمارس جراحة إستثنائية للدولة والمجتمع ، ويؤكد «الحقيقة ببساطة أننا لسنا بلدا صناعيا، ولا نستطيع أن نكون كذلك خلال ثلاثين عاماً من الآن.. فالصناعة حرفة باهظة الثمن تحتاج إلى مستويات خاصة من الخبرة والمهارات والنظم المالية المعقدة، ونحن في ليبيا لا نملك ما يكفي لصناعة علبة سردين عادية ،و بغير تعمد للسخرية: نحن لا شيء.. إننا مجرد أمة عجوز تجلس في شمال إفريقيا المحرقة وتغسل قدميها في مياه البحر والمطر وتبيع براميل الزيت. وإذا كنا قد حققنا خلال مجموعة السنوات الماضية أكثر من قفزة في ميدان التعليم والتشريع والنهوض بمستوى الحياة المادي، فإن الأمر ما يزال مجرد عمل فوق السطح. أعني مجرد محاولة لترميم جدارنا المتهدم ولكن ليس لإعادة بنائه.فالبناء يبدأ من إقامة الأساس..ويبدأ بالمسح الشامل وتوفير الطاقة المطلوبة وإعداد الخطط، ونحن - رغم كل نوايانا الطيبة - لم نتجه قط لمواجهة هذه الحقائق المتسمة بالأصالة، لقد فعلنا كل ما في وسعنا لمنح المواطن الليبي فرصة "الاستمتاع بخيرات بلاده"، كأن الله قد ألزمنا ببناء الجنة في صحراء ليبيا، وفعلنا أكثر مما في وسعنا لإشباع رغبات الفرد الصغيرة من زيادة الرواتب مرتين في الشهر إلى توزيع علاوات السكن فوق الرصيف، ورغم كل جهودنا اليائسة فإن المواطن الليبي ما يزال - مثل جهنم - يطلب المزيد، وما تزال الحقيقة القديمة أكثر ثباتاً: إن الإنسان لا يشبع. ولو كان يريد أن يفعل ذلك لما خرج من الجنة أصلاً ، فلماذا ندق رؤوسنا في الحائط؟ولماذا نواصل لعبتنا المرهقة لشراء سعادة الإنسان الليبي بنقود براميل الزيت؟ فالواقع أننا عبر هذا الخطأ نصيب أنفسنا بالدوار مرتين، ونملأ بطن مواطننا بالطعام ونضعه في الشمس لكي يحلم برمضان المعظم وفضيلة الجوع.ثم تعتريه أعراض التخمة، ويتورم بطنه مثل برميل الزيت ويقتله الملل على الرصيف، ويقتله أيضاً في الطريق إلى أثينا.. وتصبح ليبيا مقبرة المواطنين السعداء»
حتى المرأة الليبية ، يقول النيهوم «من وجهة نظرنا الحالية تعيش حرة كريمة تحت وصاية الرجل، لكننا ننسى أن أول شرط في حكاية الحرية والكرامة أن لا يعيش المرء تحت وصاية أحد غير ضميره. إن الرجل يتذكر هذه الحقيقة البسيطة فوراً إذا دعاه أحد ما إلى أن يعيش ذات مرة حراً كريماً تحت وصاية المرأة ،ومن وجهة نظرنا تبدو الأسرة الليبية خلية متماسكة لأنها تعيش تحت سقف بيت واحد وتأكل من قصعة واحدة تحت رقابة الرجل، لكننا ننسى أن هذا النوع من التماسك - إذا لم يخل من الرقابة كلية - فإنه في الواقع مجرد نوع من معسكرات الاعتقال »
ولكن جزء مهما من أسباب التخلف هي الثقافة المتوارثة «إن هذا المسلم الجديد الذي صنعه فقهاء بني أميّة على هواهم قد صار عمره الآن أربعة عشر قرنًا من دون أن يبلغ سن الرشد. فهو لا يزال مواطنًا معفيًا من مسؤوليته عن حياته، ومعفيًا من مسؤوليته عن شؤون الدولة التي تقرر مصيره، ومصير عياله أنا لا أريد هنا أن أحصر مشكلة استغلال الدين في البحث عن مصادر القوة المادية المعدة لتأدية الحروب وحدها. فالواقع أن الأمر أكثر شمولا من ذلك، وأكثر قبحا وإيغالا في السذاجة المقامة على سوء الفهم والأنانية معا.
فالعجوز المضحكة التي تتسكع لإيفاء النذور بين أضرحة الأولياء، لا تفعل ذلك في الواقع من باب الرغبة في تحقيق حيلها الصغيرة بقوة سماوية شبه سحرية، فهي تريد أن تزوج ابنتها للبقال المجاور، وتريد أن تساعد زوجها في الحصول على سكن بالمجان، وتريد أيضاً مجموعة أخرى من الأشياء المعقدة التي لا تعرف وسيلة فعالة لتحقيقها سوى أن ترشو المرابط الميت بشمعة وقليل من البخور، والمرء يستطيع بالطبع أن يكسر قلبه الحزين من أجل تلك السيدة الرقيقة الحال، ولكنه في نهاية المطاف لا يجد بدا من النظر إلى المشكلة بأسرها باعتبارها مجرد مأساة جانبية لظاهرة الافتقار إلى (قوة الله).
والفقي نصف المقدس الذي يتشنج فوق المنبر لكي يطلب من الله أن يمد في عمر سيده ويرعاه ويحفظه محنطا إلى الأبد، لا يفعل ذلك في الواقع من باب الرغبة في تأدية حق الصلاة، بل من باب الرغبة في تأدية حق وزارة الأوقاف. فهو يريد أن يحتفظ بوظيفته، ويريد أن ينال علاوة الغلاء أيضاً ما دام ذلك ممكناً. ويريد مجموعة أخرى من الأشياء المعقدة التي لا يعرف وسيلة فعالة لتحقيقها سوى أن يرفع يديه إلى السماء ويترك قوة الله تقنع وزارة الأوقاف بأنه أحسن بضاعة في السوق.
وفرقة العيساوية المتجولة التي تذرع أزفة مدننا لاستجداء رحمة الله على أرواح الموتى، لا تفعل ذلك من باب الرغبة في إنقاذ الموتى، بل من باب الرغبة في الحصول على أجرة الحضرة، فالشيخ يحتاج إلى أن يعول أسرته مثل أي مواطن آخر، ويحتاج إلى قليل من النقود في المصرف، ويحتاج إلى مجموعة أخرى من الأشياء المعقدة التي لا يعرف وسيلة فعالة لتحقيقها سوى أن يحترف الوساطة بين قوة الله وبين سكان الأزقة. والأمر يصل هنا إلى حد الاحتيال البسيط، ولكن المرء يعرف بالطبع أن الاحتيال نفسه مجرد مظهر معترف به في معركة الحصول على لقمة العيش.
والسنوسية التي بنت ألف زاوية في ليبيا، وبنت أيضاً جامعة بأسرها. لم تفعل ذلك من باب الرغبة في نقل الليبيين إلى الجنة فقط، بل من باب الرغبة في تأكيد حق السنوسيين في الحكم، وإضفاء صبغة القداسة على العرش الوراثي.
ومكة المكرمة لا تعمل الآن بمثابة مركز لالتقاء المسلمين فقط، بل لالتقاء مناصري الحلف الإسلامي أيضاً، واللعبة المشينة تمتد على طول العالم بأسره في جميع العصور وجميع الثقافات، فالإنسان البسيط التركيب الذي فعل كل ما في وسعه لكي يزيد كفاءته المادية باستئناس الثيران والبغال والآلات، لم يتوقف قط عن ارتكاب تلك الحماقة فيما يخص (استئناس) السماء أيضاً»
إن النيهوم عندما يتحدث عن نفسه يقول :« أنا لست رجلاً مهمّاً ولا صاحب سلطان.. ولكنّ إيماني بالله يجعلني أحسّ بأنّني سأظفر بصداقة كثير من الرجال الطيبين.. وقد حدث ذلك وما زال يحدث كل يوم.. وعندما تطويني غربتي وأحسّ بالألم يؤذيني من كل جانب.. أرفع رأسي إلى الله وأقول له إنّني وحيد.. أبداً لم يتخلّ الله عني.. كان يمدّني دائماً بعون ما.. بأصدقاء طيبين مثلكم.. وسوف يفعل ذلك دائماً أيضاً.. لأنّه يعلم أنّني لا أملك سواه.. ولا أريد أن أملك سواه.. أنا قويّ بإيماني.. أقوى من وحدتي وظروفي المحزنة.. وإذا التقينا في يوم ما.. فسوف أقص عليكم ما الذي يستطيع رجل وحيد مثلي أن يفعله بالإيمان وحده »
بتلك الكلمات قدم صادق النيهوم نفسه ، كان رجلا ممتلئا بالإيمان والوحدة ، مهموما بما حوله ، متأسيا بالقلم والورقة ، ليكتب وفق قوله : « لبدلة النحاس المتينة.. لأربعة آلاف ميل معبأ بالشوق والأمنيات.. للجزار وباعة العظام وسائقي عربات الأجرة والنقل.. وللخفراء والطلبة. أنا أكتب لكل من أعرفهم، وليس ثمة ما يخيفني من أي اتجاه، فالنقد لا يشعرني بالارتباك.. وإذا كان أحد لا يفهمني الآن، فسوف يأتي رجل آخر ويفهمه كل أحد على الفور . أنا لا أريد أن أحقق شيئا سوى أن أهيء مكانا لذلك الرجل القادم في الطريق.. أجعله أكثر ألفة وأعطيه فرصة ليقترب خطوتين. ما يمدّني بالقوة: أنا أعرف أنه قادم.. و أنت تعرف ذلك أيضاً»